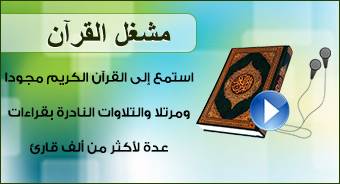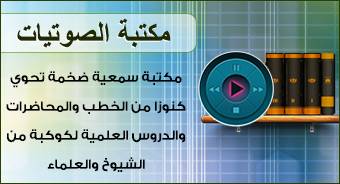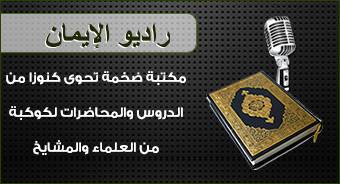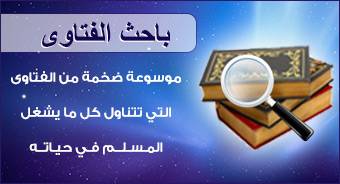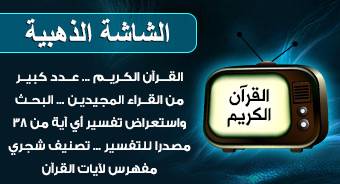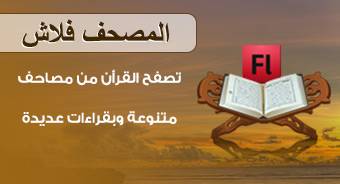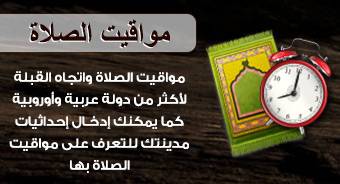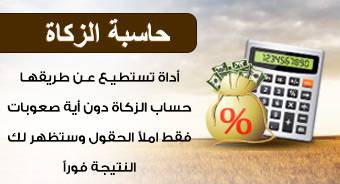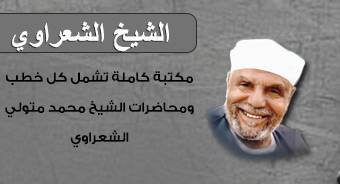.البلاغة:
.البلاغة:
1- في قوله:
{يرسل السماء عليكم مدرارا} مجاز مرسل علاقته المحلية، فقد أراد بالسماء المطر لأن المطر ينزل منها قال:
إذا نزل السماء بأرض قوم ** رعيناه وإن كانوا غضاباوالمراد بالبيت وصف شجاعتهم لأنهم إذا اجترءوا على رعي نبات القوم الغضاب فهم أحرى بأن يجترئوا على غيرهم، وفي البيت أيضا استخدام فقد أطلق السماء وأعاد عليها الضمير بمعنى النبات لأنها سببه.2- وفي قوله:
{واللّه أنبتكم من الأرض نباتا} استعارة تصريحية لأنه شبّههم بالنبات، فقد استعار الإنبات للإنشاء كما يقال زرعك اللّه للخير، وكانت هذه الاستعارة ذات فائدة لأنها دلّت على الحدوث فإنهم إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات وفيه قيل للحشوية النباتية والنوابت لحدوث مذهبهم في الإسلام.
 .الفوائد:
.الفوائد:
اختلفت أقاويل المفسرين في قوله:
{ما لكم لا ترجون للّه وقارا} ونحن نورد هنا مقتطفات من أقوالهم ثم نعقب عليها بما يجلو غامضها، فالرجاء معناه الأمل والخوف، فقال أبو عبيدة:
{لا ترجون}: لا تخافون. قالوا والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالكلام وعيد وتخويف.وعبارة الزمخشري: والمعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم اللّه إياكم في دار الثواب، وللّه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار... أو لا تخافون للّه حلما وترك معاجلة العقاب فتؤمنوا وقيل ما لكم لا تخافون للّه عظمة، وعن ابن عباس لا تخافون للّه عاقبة لأن العاقبة حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقر.وعبارة أبي حيان: وقيل ما لكم لا تجعلون رجاءكم للّه وتلقاءه وقارا ويكون على هذا منهم كأنه يقول تؤدة منكم وتمكنا في النظر لأن الفكر مظنة الخفة والطيش وركوب الرأس.وقال قطرب: هذه لغة حجازية، وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج لم أبال.وعبارة أبي السعود:
{ما لكم لا ترجون للّه وقارا} إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم للّه تعالى وقارا على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد و
{لا ترجون} حال من ضمير المخاطبين والعامل فيها معنى الاستقرار في
{لكم} و
{للّه} متعلقان بمضمر وقع حالا من
{وقارا} ولو تأخر لكان صفة له أي أيّ سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين للّه تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له
{وقد خلقكم أطوارا} أي والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهي أنكم تعلمون أنه تعالى خلقكم تارة عناصر ثم أغذية ثم أخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم أنشأكم خلقا آخر فإن التقصير في توقير من هذه شئونه في القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلم بها مما لا يكاد يصدر عن العاقل.والذي يتحصل معنا من هذا كله: هو أن القوم كانوا يبالغون في احتقاره عليه السلام والاستهزاء به والتندّر عليه فأمرهم اللّه بالتزام الجدّ في توقيره واحترامه والصدوف عن هذه المعاملة غير اللائقة، أي أنكم إذا وقرتم نوحا وتركتم الاستخفاف به والتندّر عليه كان ذلك طاعة للّه وتقربا إليه وامتثالا لأوامره فما لكم لا تهتبلون هذه الفرصة فتفوزوا برضا اللّه بتوقيره واحترامه؟
 .[سورة نوح: الآيات 21- 28]
.[سورة نوح: الآيات 21- 28]
{قال نُوحٌ ربِّ إِنّهُمْ عصوْنِي واتّبعُوا منْ لمْ يزِدْهُ مالُهُ وولدُهُ إِلاّ خسارا (21) ومكرُوا مكْرا كُبّارا (22) وقالوا لا تذرُنّ آلِهتكُمْ ولا تذرُنّ ودّا ولا سُواعا ولا يغُوث ويعُوق ونسْرا (23) وقدْ أضلُّوا كثِيرا ولا تزِدِ الظّالِمِين إِلاّ ضلالا (24) مِمّا خطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فأُدْخِلُوا نارا فلمْ يجِدُوا لهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أنْصارا (25) وقال نُوحٌ ربِّ لا تذرْ على الْأرْضِ مِن الْكافِرِين ديّارا (26) إِنّك إِنْ تذرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادك ولا يلِدُوا إِلاّ فاجِرا كفّارا (27) ربِّ اغْفِرْ لِي ولِوالِديّ ولِمنْ دخل بيْتِي مُؤْمِنا ولِلْمُؤْمِنِين والْمُؤْمِناتِ ولا تزِدِ الظّالِمِين إِلاّ تبارا (28)} .اللغة:
.اللغة:
{كُبّارا} بضم الكاف وتشديد الباء وهو بناء مبالغة أبلغ من كبار بالضم والتخفيف. (ود، سواع، يغُوث، يعُوق، نسر) أسماء أصنام كانوا يعبدونها.
{ديّارا} قال الزمخشري: من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال ما بالدار ديار وديور كقيام وقيوم وهو فيعال من الدوار أو من الدار وأصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت ولو كان فعالا لكان دوارا.وعبارة أبي حيان: ديارا من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي وما أشبهه ووزنه فيعال أصله ديوار اجتمعت الياء والواو وسبقت أحداهما بالسكون فأدغمت.وفي القاموس: وما به داريّ وديّار ودوريّ وديّور: أحد.
{تبارا} هلاكا.
 .الإعراب:
.الإعراب:
{قال نُوحٌ ربِّ إِنّهُمْ عصوْنِي} {قال نوح} فعل ماض وفاعل و
{رب} منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وإن واسمها وجملة
{عصوني} خبرها والجملة مقول القول.
{واتّبعُوا منْ لمْ يزِدْهُ مالُهُ وولدُهُ إِلّا خسارا} {واتبعوا} عطف على
{عصوني} و
{من} مفعول به و
{لم} حرف نفي وقلب وجزم و
{يزده} فعل مضارع مجزوم بـ:
{لم} والهاء مفعول به و
{ماله} فاعل
{وولده} عطف على
{ماله} و
{إلا} أداة حصر و
{خسارا} مفعول به ثان لـ:
{يزده}.
{ومكرُوا مكْرا كُبّارا} الواو عاطفة و
{مكروا} فعل ماض وفاعل و
{مكرا} مفعول مطلق و
{كبارا} نعت لـ:
{مكرا} أي عظيما جدا.
{وقالوا لا تذرُنّ آلِهتكُمْ ولا تذرُنّ ودّا ولا سُواعا ولا يغُوث ويعُوق ونسْرا} الواو عاطفة و
{قالوا} فعل ماض وفاعل و
{لا} ناهية و
{تذرن} فعل مضارع مجزوم بـ:
{لا} وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة و
{آلهتكم} مفعول به، و
{لا تذرن} عطف على
{لا تذرن} الأولى و
{ودّا} وما عطف عليه مفعول
{تذرن} {ويغوث ويعوق} ممنوعان من الصرف للعلمية ووزن الفعل إن كانا عربيين والعلمية والعجمة إن كانا أعجميين، وقرئ
{ولا يغوثا ويعوقا} مصروفين لأمرين أحدهما أن صرفهما للتناسب إذ قبلهما اسمان منصرفان وبعدهما اسم منصرف والثاني أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقا وهي لغة حكاها الكسائي.
{وقدْ أضلُّوا كثِيرا ولا تزِدِ الظّالِمِين إِلّا ضلالا} الواو عاطفة وجملة
{قد أضلّوا} مقول قول محذوف معطوف على قال السابقة أي قال إنهم عصوني وقال قد أضلّوا. و
{أضلّوا} فعل وفاعل و
{كثيرا} مفعول به والواو عاطفة على القول المحذوف قال الزمخشري: فإن قلت علام عطف قوله:
{ولا تزد الظالمين} قلت على قوله:
{رب إنهم عصوني} على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد قال وبعد الواو النائبة عنه ومعناه قال رب إنهم عصوني وقال لا تزد الظالمين إلا ضلالا أي قال هذين القولين وهما في محل النصب لأنهما مفعولا
{قال} و
{لا} ناهية و
{تزد} فعل مضارع مجزوم بلا و
{الظالمين} مفعول و
{إلا} أداة حصر و
{ضلالا} مفعول به وعبارة أبي حيان:
{ولا تزد} عطف على
{قد أضلّوا} لأنها محكية بقال مضمرة ولا يشترط التناسب في الجمل المتعاطفة بل يعطف خبر على طلب وبالعكس خلافا لمن اشترطه.وعبارة الشهاب الخفاجي: يعني
{لا تزد} مقول ثان لنوح عليه السلام، عطف اللّه أحد مقوليه على الآخر والواو فيه من كلامه تعالى لا من كلام نوح لاستلزامه عطف الإنشاء على الإخبار فحكى اللّه أحد مقوليه بتصديره بلفظ قال وحكى قوله الآخر بعطفه على قوله الأول بالواو النائبة عن لفظ
{قال}.
{مِمّا خطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فأُدْخِلُوا نارا} {من} حرف جر و
{ما} زائدة و
{خطيئاتهم} مجرور بمن التعليلية والجار والمجرور متعلقان بـ:
{أغرقوا} و
{أغرقوا} فعل ماض مبني للمجهول،
{فأدخلوا} عطف على
{أغرقوا} وجعل دخولهم النار متعقبا لإغراقهم نظرا لاقترابه ولأنه كائن لا محالة فكأنه قد كان
{ونارا} مفعول به ثان على السعة.
{فلمْ يجِدُوا لهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أنْصارا} عطف متعقب أيضا ولم حرف نفي وقلب وجزم و
{يجدوا} فعل مضارع مجزوم بلم و
{لهم} في موضع المفعول الثاني لـ:
{يجدوا} و
{من دون اللّه} حال و
{أنصارا} مفعول
{يجدوا} الأول.
{وقال نُوحٌ ربِّ لا تذرْ على الْأرْضِ مِن الْكافِرِين ديّارا} الواو عاطفة و
{قال نوح} فعل ماض وفاعل و
{رب} منادى محذوف منه حرف النداء وهو مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة و
{لا} ناهية و
{تذر} فعل مضارع مجزوم بـ:
{لا} و
{على الأرض} متعلقان بـ:
{تذر} و
{من الكافرين} حال لأنه كان في الأصل صفة لـ:
{ديارا} و
{ديارا} مفعول
{تذر}.
{إِنّك إِنْ تذرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادك ولا يلِدُوا إِلّا فاجِرا كفّارا} إن واسمها والجملة تعليل لطلب نوح عليه السلام، فإن قيل كيف علم أن أولادهم يكونون مثلهم أجيب بأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فاكتنه دخائلهم وسبر أغوارهم فقد كان الرجل منهم ينطلق بابنه ويقول له: احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي قد حذرني منه فيموت الكبير وينشأ الصغير على ما كان والده قد لقنه وعلمه من قبل.و
{إن} شرطية و
{تذرهم} فعل الشرط والهاء مفعول به و
{يضلّوا} جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر
{إنك} و
{عبادك} مفعول به والواو حرف عطف و
{لا} نافية و
{يلدوا} فعل مضارع معطوف على
{يضلوا} والواو فاعل و
{إلا} أداة حصر و
{فاجرا} مفعول
{يضلّوا} و
{كفّارا} نعت.
{ربِّ اغْفِرْ لِي ولِوالِديّ ولِمنْ دخل بيْتِي مُؤْمِنا ولِلْمُؤْمِنِين والْمُؤْمِناتِ} {رب} منادى مضاف وقد تقدمت له نظائر، و
{اغفر} فعل دعاء و
{لي} متعلقان بـ:
{اغفر} {ولوالدي} عطف على
{لي} {ولمن} عطف أيضا وجملة
{دخل بيتي} صلة الموصول و
{مؤمنا} حال
{وللمؤمنين والمؤمنات} عطف أيضا.
{ولا تزِدِ الظّالِمِين إِلّا تبارا} الواو عاطفة و
{لا} ناهية دعائية و
{تزد} فعل مضارع مجزوم بلا و
{الظالمين} مفعول به أول و
{إلا} أداة حصر و
{تبارا} مفعول به ثان والاستثناء مفرغ.وفي المصباح: وتبر يتبر من بابي قتل وتعب إذ هلك ويتعدى بالتضعيف فيقال تبره والاسم التبار، والفعال بالفتح يأتي كثيرا من فعّل نحو كلم كلاما وسلّم سلاما وودّع وداعا.
 .البلاغة:
.البلاغة:
في قوله:
{ولا يلدوا إلا فاجرا كفّارا} مجاز مرسل علاقته ما يئول إليه لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل على كل حال. اهـ.
 .قال أبو البقاء العكبري:
.قال أبو البقاء العكبري:
سورة نوح عليه السلام:بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِقوله تعالى:
{أن أنذر} يجوز أن تكون بمعنى أي، وأن تكون مصدرية، وقد ذكرت نظائره، و
{طباقا} قد ذكر في الملك، و
{نباتا} اسم للمصدر فيقع موقع إتبات؟؟؟ ونبت وتنبيت، وقيل التقدير: فنبتم نباتا، و
{منها} يجوز أن يتعلق بتسلكوا، وأن يكون حالا، و
{كبارا} بالتشديد والتخفيف بمعنى كبير، و
{ودا} بالضم والفتح لغتان، وأما (يغوث ويعوق) فلا ينصرفان لوزن الفعل والتعريف.وقد صرفهما قوم على أنهما نكرتان.قوله تعالى:
{مما خطاياهم} {ما} زائدة.أي من أجل خطاياهم
{أغرقوا} وأصل
{ديارا} ديوار لأنه فيعال من دار يدور ثم أدغم. اهـ.